جزالة
-قال نوفلُ بنُ مساحقٍ القرشيُّ:
«أنا رأيتُ مجنونَ بني عامر، وكان جميلَ الطلعة، أبيضَ اللون، قد غشيه شحوبٌ، فاستنشدتُه فأنشدني:تذكّرتُ ليلى والسنينَ الخواليا…».
-وقال أيوبُ بنُ عباية:
«سألتُ بني عامرٍ بطناً بطناً عن مجنونهم فما وجدتُ أحداً يعرفه».
المفارقة
يقف الباحثُ هاهنا على مفارقةٍ تستعصي على التفسير الساذج: شهادةُ عيانٍ دقيقةٌ تُحدّد ملامح الوجه ولون البشرة وتسمعنا بيتًا من الشعر على لسان صاحبه، في مقابل روايةٍ متأخرةٍ تنفي أصلَ وجوده، وتزعمُ أنّ القبيلةَ برُمّتها لم تعرف ابنَها ولا سمعت له بذكر.
وليس التناقضُ في الصورة، بل الأعجبُ أنّ الوسطَ الأدبيَّ استوعبَ الروايتين معًا، ونقلَهما الرواةُ كأنّ السردَ التاريخيَّ يتّسع لثبوت الشيء ونفيه في آنٍ واحد. والأغربُ من ذلك أنّ الروايةَ النافية — مع تأخّرها زمانًا واضطراب منهجها — نالت عند طائفةٍ من المحدَثين منزلةَ "النقد المستنير"، حتى غدا إنكارُ وجود قيس بن الملوّح يُسوَّق بوصفه كشفًا لأسطورةٍ منتحلة، كأنّ النفيَ اللاحقَ أصدقُ من وصفٍ معاصرٍ ركّز أدقَّ السماتِ الحسية.
الإشكالية
من هنا ينبثق سيلٌ من الأسئلة يفرضُ نفسه على العقل الناقد:
كيف تُوزن شهادةُ قرشيٍّ من أهل القرن الأول (توفّي سنة 74هـ) يصف ما رآه بعينه، أمام إنكارٍ جاء بعد قرنٍ أو أكثر؟
ما حقيقةُ "التحقيق البطَنيّ" الذي ادّعاه ناقلُ النفي، إذ زعم أنه طافَ بطونَ بني عامر بطناً بطناً يسألهم عن شاعرٍ واحدٍ؟
وغيرة من المواجهات نعرضها في سياقها وهم عصبُ هذا البحث ومِحوره. سنزنُ كلَّ شهادةٍ بميزان قربها الزمنيّ، ونفتّش عن صدق سندها، ونستجلي الباعث الذي أملى على الراوي أن يُثبت أو أن يُنكر. غايتُنا ليست استسلامًا للشكّ العاجز، ولا تبنّيًا أعمى للمأثور، وإنما التمييزُ بين نواةٍ صلبةٍ من الحقيقة، وبين ما نُحلَ حولها من خلطٍ ورواياتٍ وأساطير.
منهجية التحقيق
لن نسلكَ سبيلَ المطمئنين إلى كلّ منقولٍ، ولا دربَ الرافضين بالجملة، بل نأخذ من التحقيق النقديّ مذهبًا، ومن مقابلة الشهادات منهجًا، ومن تحليل الأزمنة والسياقات كاشفًا لما استتر من الحقائق وراء ضباب الروايات.
وسنجعل كلَّ شهادةٍ عُرضةً لميزانٍ صارم، لا يُحابِي ولا يلين:
- قربُ الزمان: فقولُ المعاصر ليس كدعوى المتأخّر.
- الإمكانُ العملي: فما جاز عقلًا وعادةً ليس كالمستحيل.
- القرائنُ المحيطة: فالسياقُ التاريخي يكشف ما تتستّر به الألفاظ.
- التحليلُ اللغويّ: إذ قد تفضح العباراتُ نوايا قائلها، وتُبدي ما أراد أن يخفيه.
وهنا يحسنُ استدعاء قول الأصمعيّ — وهو إمامٌ في هذا الباب — إذ قال: «لم يكن مجنونًا، ولكن كانت به لوثةٌ كلوثة أبي حيّة النميري». فهو إذن يُثبِت الوجود، ويُعدّل في الوصف، فلا ينكر الأصل جملةً، ولا يُهوّل حتى يسقط في شَرَك الأسطورة. وذلك هو الموقف الوسط الذي يليق بالعقل النقدي: تمييز الحقيقة من الوهم، دون أن يُسقط الكلَّ في العدم، ولا أن يبتلع الكلَّ في التصديق الأعمى.
وكذلك قولُ الجاحظ شاهدٌ آخر على المنهج الرصين: «ما ترك الناسُ شعرًا مجهولَ القائل قيل في ليلى إلا نسبوه إلى المجنون». فكأنّه يقرّ بوجود أصلٍ ثابت تُعلّق عليه الزوائد، إذ كيف تُعلَّق النصوص بمعدوم؟ وكيف يُحمَّل الوهمُ ما لا يحتمله الواقع؟
فليكن مقصدنا — ونحن نُقبل على هذه الشهادات — أن نُمحّصها بالغربال: نفرّقُ بين الغثّ والسمين، والمُرسَل والمُسنَد، والدعوى والبرهان؛ لعلّنا نصل إلى كلمةٍ سواء في قضيّةٍ شغلت الناس، وأثارت الجدل كلّما ذُكر العشقُ وأهله، والشعرُ ومجانينه.
وقبل ادخلك في الدوامة, قيس بن الملوح, قال الأصفهاني في كتاب الأغاني:
هو - على ما يقوله من صحّح نسبه وحديثه - قيس، وقيل: مهديّ، والصحيح [أنه] قيس بن الملوّح بن مزاحم بن عدس بن ربيعة بن جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. ومن الدليل على أنّ اسمه قيس قول ليّلى صاحبته فيه:
ألا ليت شعري والخطوب كثيرة
متى رحل قيس مستقلّ فراجع
الفصل الأول: شهادات المعاصرين المثبتة
- شهادة نوفل بن مساحق القرشي (ت 74هـ)
يُعدّ نوفل بن مساحق من أوثق الشهود وأقربهم إلى زمن الأحداث، فهو — كما في الأغاني —: «نوفل بن مساحق بن عبد الله بن مخرمة بن عبد العُزّى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي القرشي»، من أهل المدينة المنوّرة، تُوفّي سنة أربع وسبعين للهجرة.
1. اللقاء المباشر
جاء في الأغاني بسند متصل:
«أخبرني أحمد بن عمر بن موسى بن زكريّا القطان إجازة، قال: حدّثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، قال: أخبرني عبد الجبار بن سليمان بن نوفل بن مساحق، عن أبيه، عن جدّه قال: أنا رأيت مجنون بني عامر، وكان جميل الوجه، أبيض اللون، قد علاه شحوب، واستنشدته فأنشدني قصيدته التي يقول فيها:
تَذَكَّرتُ لَيلى وَالسِنينَ الخَوالِيا
وَأَيّامَ لا نَخشى عَلى اللَهوِ ناهِيا
وَيَومٍ كَظِلِّ الرُمحِ قَصَّرتُ ظِلَّهُ
بِلَيلى فَلَهّاني وَما كُنتُ لاهِيا
2. اللقاء في البادية
وفي موضع آخر من الأغاني يروي الأصفهاني عن نوفل لقاءً آخر:
«قال نوفل: قدمتُ البادية فسألت عنه فقيل لي…» [ثم يروي لقاءه به في البرية] «فقلت له: ما أحدثتَ بعدي في يأسك منها؟ فأنشدني يقول:
ألا حُجِبَت ليلى وآلى أميرُها
عليّ يمينًا جاهداً لا أزورُها
قال: ثم سنحت له ظباءٌ، فقام يعدو في أثرها حتى لحقها فمضى معها».
تحليل شهادة نوفل
نوفل تُوفّي سنة 74هـ، والمجنون تُرجّح الروايات أنه عاش بين (24–68هـ). أي أنّ نوفل عاصره حقًّا، وشهد لقاءه في أكثر من موضع.
شهادة إبراهيم بن سعد الزهري
أورد السيوطي في شرح شواهد المغني:
«أخرج [الأصفهاني] عن إبراهيم بن سعد الزهري قال: أتاني رجلٌ من عُذرة لحاجة، فجرى ذكر العشق والعشّاق، فقلت له: أنتم أرقُّ قلوبًا أم بنو عامر؟ فقال: إنا لأرقُّ الناس قلوبًا، ولكن غلبتنا بنو عامر بمجنونها».
التحليل
اعتراف صريح من قبيلة عُذرة بوجود المجنون. والعربُ كانوا يتفاخرون بالشعراء كما يتفاخرون بالفرسان. فلو كان المجنون وهمًا، لأنكره العُذري وادّعى الفخر لعشيرته.
شهادة الأعرابي اليمني
روى عمرو بن أبي عمرو الشيباني:
«حدّثني رجلٌ من أهل اليمن أنّه رآه ولقيه، وسأله عن اسمه ونَسَبه، فذكر أنّه قيس بن الملوّح».
الفصل الثاني: مفارقة الإنكار
أولًا: دعوى أيوب بن عباية
أورد الأصفهاني في الأغاني:
«أخبرني حبيب بن نصر المهلبي وأحمد بن عبد العزيز الجوهري عن ابن شَبّة عن الحزامي قال: حدّثني أيوب بن عباية قال: سألتُ بني عامر بطنًا بطنًا عن مجنون بني عامر، فما وجدتُ أحدًا يعرفه».
وجاء عند اليغموري في نور القبس:
«وقال ابن دأب: سألتُ بطون بني عامر بطنًا بطنًا عن مجنون بني عامر، فما وجدتُ أحدًا يعرفه».
التحليل النقدي للدعوى:
كما قال أحد النقّاد المعاصرين (الأدب المقارن – جامعة المدينة):
«من ذا الذي لديه مثل ذلك الفراغ الطويل والصبر العجيب حتى يطوف ببطون بني عامر جميعًا، سائلاً في كل بطن عن شاعر، وكأنه يؤدي مهمة مقدسة؟ وهل كان الناس ليتركوا مثل ذلك الملحف في السؤال والبحث، فلا يجعلوه هدفًا لعبثهم وتهكمهم، إن لم يكن لشتمهم واتهامهم في عقله؟ لو صحّت هذه الجولة المزعومة، فكيف لم يُنقل إلينا عن أيٍّ من بني عامر أنهم شهدوا على هذا السائل، وأجمعوا على إنكار وجود شاعر يُدعى المجنون؟ أليس هذا الغياب في حد ذاته علامةً على وهَن الرواية؟
وأقول انا اني بحثت عن "أيوب بن عباية" فلم اجد عنه شيء غير في سياق قيس بن الملوح.
"المؤامرة" الاموية:
جاء في شرح شواهد المغني للسيوطي:
قال عوانة الكلبي: «إنّ المجنون وشِعره وضعه فتى من بني أميّة كان يهوى ابنةَ عمّ له، وكان يكره أن يظهر، فوضع حديث المجنون وقال الأشعار التي يرويها الناس للمجنون ونسبها إليه».
التحليل النقدي لرواية "المؤامرة"
اللامعقولية التاريخية:
كيف يمكن لفتى واحد أن يخدع العرب قاطبة، فينسب الشعر إلى شخص لا وجود له؟
كيف لم يُفضحه قومه الأقربون؟
ولماذا قبِل الناس شعرًا منسوبًا لرجل لم يُعرف في بيئة العرب بشهادة معاصريه؟
الفصل الثالث: الأصمعي وإشكالية الشهادة المتناقضة
الأصمعي (ت 216هـ) أحد أعمدة الرواية الأدبية في التراث العربي، ومن أكثر الرواة ضبطًا ونقلاً في أخبار الشعراء. غير أنّ ما نُسب إليه في شأن مجنون بني عامر يضعنا أمام تناقض صارخ، يستحيل أن يصدر عن عالم واحد في مسألة واحدة.
القول الأول: الإثبات مع التعديل
في الأغاني وردت عنه روايتان متقاربتان في المعنى:
قال: «لم يكن مجنونًا، ولكن كانت به لوثة كلوثة أبي حيّة النميري».
وقال في موضع آخر: «أُضيف إلى المجنون من الشعر أكثر مما قاله، ولم يكن مجنونًا، بل كانت به لوثة أحدثها العشق فيه».
المعنى المشترك بين الروايتين: الأصمعي يثبت وجود المجنون شخصًا وشعرًا، لكنه يهوّن من صفة الجنون، ويصفها بأنها لوثة عشق، لا جنون مطبق.
القول الثاني: النفي المطلق
ويُنسب إليه كذلك قوله:
«رجلان ما عُرفا في الدنيا قط إلا بالاسم: مجنون بني عامر، وابن القرية».
هذا القول – لو صح – لا يثبت وجودًا ولا شعراً، بل يلغيهما من الأصل.
المتأمل يجد أن هذه المقولة النافية تعاني من غياب مريب:
غيابها عن ابن سعيد المغربي (610–685هـ) في المرقصات والمطربات:
- رغم أنّه ينقل عن الأصمعي في نفس الموضوع.
- رغم استقصائه روايات المجنون شعرًا وخبرًا.
- رغم اعتماده على نفس المصادر (الأغاني والرياشي).
غيابها عن السيوطي (ت 911هـ) في شرح شواهد المغني:
- مع أنه حشد كل ما رُوي في نفي وجود المجنون.
- ومع أنه نقل الأقوال الأخرى المثبتة عن الأصمعي.
التحليل النقدي للتناقض
استحالة الجمع
كيف يمكن أن يجتمع في قول واحد:
«كانت به لوثة» = إثبات وجود شخص وحال.
«ما عُرف قط إلا بالاسم» = نفي وجود أصلاً.
هذا كمن يقول: «رأيت زيدًا وكان أعرج» ثم يزعم: «زيد لم يُخلق أصلًا»!
القرينة الترجيحية
الروايات المثبتة: متعدّدة الأسانيد، مفصّلة، منقولة في مصادر رصينة.
الرواية النافية: يتيمة، غامضة المصدر، غائبة عن أهم كتب النقل.
الدلالة العميقة
قول الأصمعي: «أُضيف إلى المجنون من الشعر أكثر مما قاله» اعتراف ضمني بثلاث طبقات:
أن هناك شعرًا قاله فعلاً.
وأن هناك شعرًا أُضيف إليه.
وأن التمييز بين الأصيل والدخيل فرع عن التسليم بوجود أصل.
الفصل الرابع: تعدّد المجانين
إذ ينقل الأغاني عن الأصمعي شهادة تفتح بابًا جديدًا في تفسير الظاهرة:
«سألتُ أعرابيًا من بني عامر بن صعصعة عن المجنون العامري، فقال: أيّهم تسألني؟ فقد كان فينا جماعة رُموا بالجنون. فعن أيّهم تسأل؟ فقلت: عن الذي كان يشبّب بليلى. فقال: كلّهم كان يشبّب بليلى!»
ثمّ عدّد الأعرابي ثلاثة منهم:
مزاحم بن الحارث المجنون
قال:
ألا أيّها القلب الذي لجّ هائماً
بليلى وليداً لم تُقطّع تمائمه
معاذ بن كليب المجنون
قال:
ألا طالما لاعبت ليلى وقادني
إلى اللهو قلبٌ للحسان تبوع
مهدي بن الملوّح
قال:
لو أن لك الدنيا وما عدلتَ به
سواها وليلى حائل عنك بينها
لكنْتَ إلى ليلى فقيراً، وإنّما
يقول إليها ودّ نفسك حينها
فلما طلب الأصمعي الاستزادة، قال الأعرابي:
«حسبك! فوالله إن في واحد من هؤلاء لمن يوزن بعقلائكم اليوم!»
شهادة ابن الأعرابي:
وفي الأغاني أيضًا نجد ما يعزّز هذا الاتجاه، إذ قال ابن الأعرابي:
«كان معاذ بن كليب مجنونًا وكان يحب ليلى، وشركه في حبّها مزاحم بن الحارث العقيلي».
بل إن مزاحم خاطب معاذًا يومًا بقوله:
كلانا يا معاذ بحبّ ليلى
بفيّ وفيك من ليلى التراب
شركتك في هوى من كان حظّي
وحظّك من مودتها العذاب
لقد خبّلت فؤادك ثم ثنّت
بعقلي، فهو مخبولٌ مُصاب
الفصل الخامس: التناقض القبلي – بنو عامر بين الإنكار والإقرار
رواية ابن دأب
«قلتُ لرجل من بني عامر: أتعرف المجنون وتروي من شعره شيئًا؟ فقال: أوقد فرغنا من شعر العقلاء حتى نروي أشعار المجانين؟ إنهم لكُثُر! فقلت: ليس هؤلاء أعني، إنما أعني مجنون بني عامر، الشاعر الذي قتله العشق. فقال: هيهات! بنو عامر أغلظ أكبادًا من ذاك، إنما يكون هذا في هذه اليمانية الضعاف قلوبها».
رواية الحكم بن صالح
«سأل رجلًا من بني عامر عن المجنون الذي قتله العشق، فقال: هذا باطل، إنما يقتل العشق هذه اليمانية الضعاف القلوب».
وتضدها شهادة الإقرار من قلب القبيلة فرغم هذا النفي، نُقل عن أبي ثمامة الجعدي العامري قوله:
«لا يُعرف فينا مجنون إلا قيس بن الملوّح».
تفسير التناقض:
بعض العامريين يقول: «نحن أغلظ أكبادًا من أن يقتلنا العشق».
أبو ثمامة، وهو عامري مثلهم، يقول: «لا يُعرف فينا مجنون إلا قيس».
فكيف تُنكر القبيلة وتُقرّ في آنٍ واحد؟
التفسير المنطقي ان الإنكار جاء من رجال رأوا في الجنون العشقي عارًا لا يليق بسمعة القبيلة. والإقرار صدر ممّن لم يجد في الاعتراف بذلك غضاضة.
الفصل السادس: شهادة المتأخرين
شهادة الذهبي (673-748هـ) – بعد ستة قرون
في سير أعلام النبلاء يقول الذهبي:
«وشِعْرُهُ كثيرٌ من أرقّ شيءٍ وأعذبه، وكان في دولة يزيد، وابن الزبير».
ويضيف في موضع آخر – كما نقله عنه صاحب الأدب المقارن:
«وهو ما يدلّ على أن ذلك الشعر ذو ماءٍ واحد، وينفح بعبقٍ واحد».
على الرغم من المفارقة الزمنية، فإن حكم الذهبي يكشف عن انطباع نقديٍّ عام حول وحدة النَفَس الشعري. هذا يؤكد أن بين أيدينا شعراً يخرج من معين واحد، لا من توليفة عشوائية. وبذلك يكون قوله سندًا متأخرًا، يعزّز فرضية وجود شاعر حقيقي احيل له من الشعر الذي وازاه في مستواه، ويدحض فكرة الاختلاق المطلق.
الفصل التاسع: السردية المُرجَّحة, من الحقيقة إلى الأسطورة إلى الإنكار
بعد أن استعرضنا الشهادات المتناقضة وفككنا خيوط الروايات، يمكننا أن نرسم الخط البياني الأكثر معقولية لمسار الظاهرة:
المرحلة الأولى: الوجود التاريخي (20 – 70هـ)
- الحقيقة الأولية: في بني عامر شبان أصابتهم لوثة العشق، أشهرهم قيس بن الملوّح، وربما معاذ بن كليب، أو مزاحم بن الحارث.
- القاسم المشترك: كلهم عشق نساءً يُدعين ليلى، وهو اسم شائع في القبيلة.
- الشهادة القاطعة: نوفل بن مساحق (ت 74هـ) – وهو معاصر – صرّح أنه لاقى قيس بن الملوّح المجنون بليلى.
- البيئة الثقافية: الشعر كان الوسيلة الأولى للتعبير، والجنون العشقي ظاهرة معترف بها، كما قال الأصمعي: «كلوثة أبي حيّة النميري».
المرحلة الثانية: التبلور الأسطوري (70 – 150هـ)
الانصهار والتداخل: تعددت القصص، وتشابهت الأشعار، فاندمجت في شخصية واحدة هي قيس بن الملوّح.
آلية المغناطيس الشعري: وصفها الجاحظ بعبارة فذّة: «ما ترك الناس شعراً مجهول القائل قيل في ليلى إلا نسبوه إلى المجنون».
القانون الأدبي:
- كل شعر عشق مجهول ← يُنسب للمجنون.
- كل قصة هيام في القبيلة ← تُلحق بقصته.
- كل بيت في ليلى ← يُضاف إلى ديوانه.
وهذا إن دلّ، فإنما يدلّ على أن شخصية حقيقية, أطلقت شرارة في الذاكرة العربية، فالتصقت بها القصائد، وتشابكت حولها الأساطير، حتى غدت رمزًا خالدًا يتجاوز صاحبه وان كان شاعرا جزل.
النتائج
أولاً: ميزان الأدلة
إذا وضعنا الشهادات في كفتي الميزان، ظهر لنا ما يلي:
كفة الإثبات
- شهادة العيان المباشرة: نوفل بن مساحق (ت. 74هـ)، قرشيّ ثقة، معاصر، روى لقاءات حسية متكررة مع قيس.
- اعتراف عُذرة تقرّ بالمجنون، وكان من مصلحتها إنكاره لا إثباته.
- تعدد الشهود المستقلين: عبد الجبار الساعي، واليمني من خارج الإقليم، وأبو ثمامة العامري من داخل القبيلة نفسها.
- شهادة الأصمعي: أثبت الظاهرة مع تعديل دقيق («لوثة» لا جنون مطبق).
- تعدد المجانين الحقيقيين: يفسّر التضارب، ويؤكد أن الظاهرة لم تكن اختراعاً بل واقعاً عشناه في نصوص وشواهد.
كفة النفي
- شهادات متأخرة بأكثر من قرن، بلا شهود عيان ولا تفاصيل حسية.
- محاولات تحقيق مشكوك فيهت «بطناً بطناً».
ففي هذا حكمة خطر الإفراط النقدي. ليس كل عجيب خرافة، وليس كل قديم وهماً. أحياناً يكون المبالغة في النقد أبعد عن الحقيقة من التصديق المتزن.
وفخ الأحكام المطلقة: الحقيقة غالباً وسطٌ بين الإفراط والتفريط؛ تضخيم الأسطورة لا ينفي وجود النواة التاريخية.
وأهمية التحليل الطبقي للمصادر:
معاصر ≠ متأخر
شاهد عيان ≠ ناقل
تفصيل ≠ إجمال
الحمد لله
الدرس الأعمق هنا ليس في إثبات قيس أو نفيه، بل في تعرية آفة منهجية تنخر في جسد الدراسات التاريخية: الانبهار بالإنكار، والافتتان بالتشكيك، وتقديم النفي المتأخر على الإثبات المعاصر.
فكم من حقيقة تاريخية طُمست تحت وطأة "النقد العلمي" الذي هو في جوهره تشكيك متعسف؟ وكم من شهادة عيان أُهملت لصالح نظرية وُلدت بعد قرون؟ وكم من وجود حقيقي جرى اختزاله إلى "رمز أدبي" إرضاءً للنزعة الشكية؟
إن إعادة الاعتبار لقيس بن الملوّح – أو للمجانين الذين انصهروا في شخصيته – ليست مجرد تصحيح خطأ تاريخي، بل هي دعوة لإصلاح منهجي عميق: أن نُفرّق بين النقد الرصين والتشكيك الأعمى، بين التحقيق العلمي والإنكار المتعسف.
وفي النهاية تبقى الحقيقة البسيطة التي غابت عن كثيرين:
- الأساطير لا تُخلق من فراغ، بل تنمو حول بذرة من حقيقة.
ومهمة المؤرخ ليست إنكار الشجرة كلها، بل التمييز بين الجذع والأغصان، بين النواة التاريخية والقشرة الأسطورية.
هذا، والله أعلم بالحقائق، وهو الهادي إلى سراط مستقيم.
تنويه: هذا البحث نتاج جهدٍ فردي بالاعتماد على المصادر المتاحة لدى الباحث وإصداراتها المحقّقة. المصادر في التراث كثيرٌ ومتشعّبٌ، وبعض المخطوطات والنسخ والكتب لم تقع تحت يدي أثناء إعداد هذه الدراسة. إن كنت من المهتمّين أو لديك ملاحظة توثيقية أو نسخة مخطوطة تضيف أو تصحّح معلومة، فأرحّب بمساهمتك وتصويبك.
الهدف أن نُقدّمَ هذه المادة في أفضل صورةٍ ممكنة، ونفتحُ باب التحقيق الجماعي لصوغ صورةٍ أوضح عن «مجنون ليلى» ونواته التاريخية.
 عبدالرحمن الروقي
عبدالرحمن الروقي 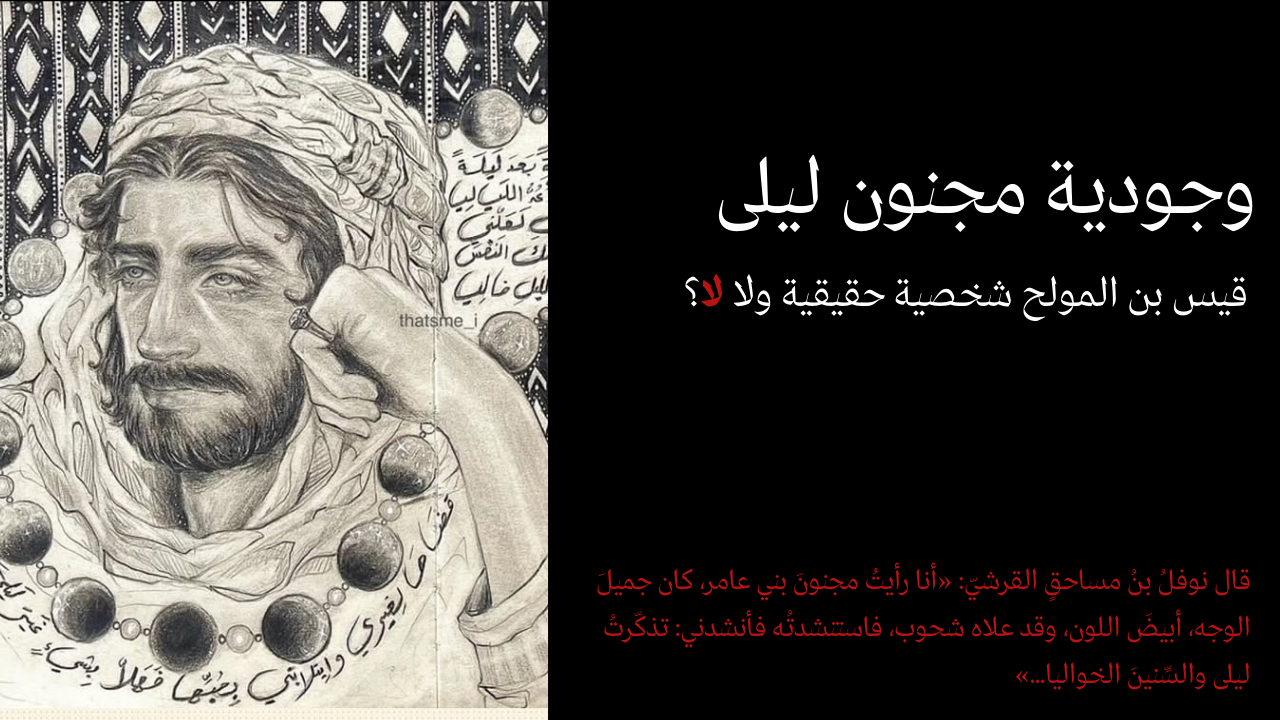

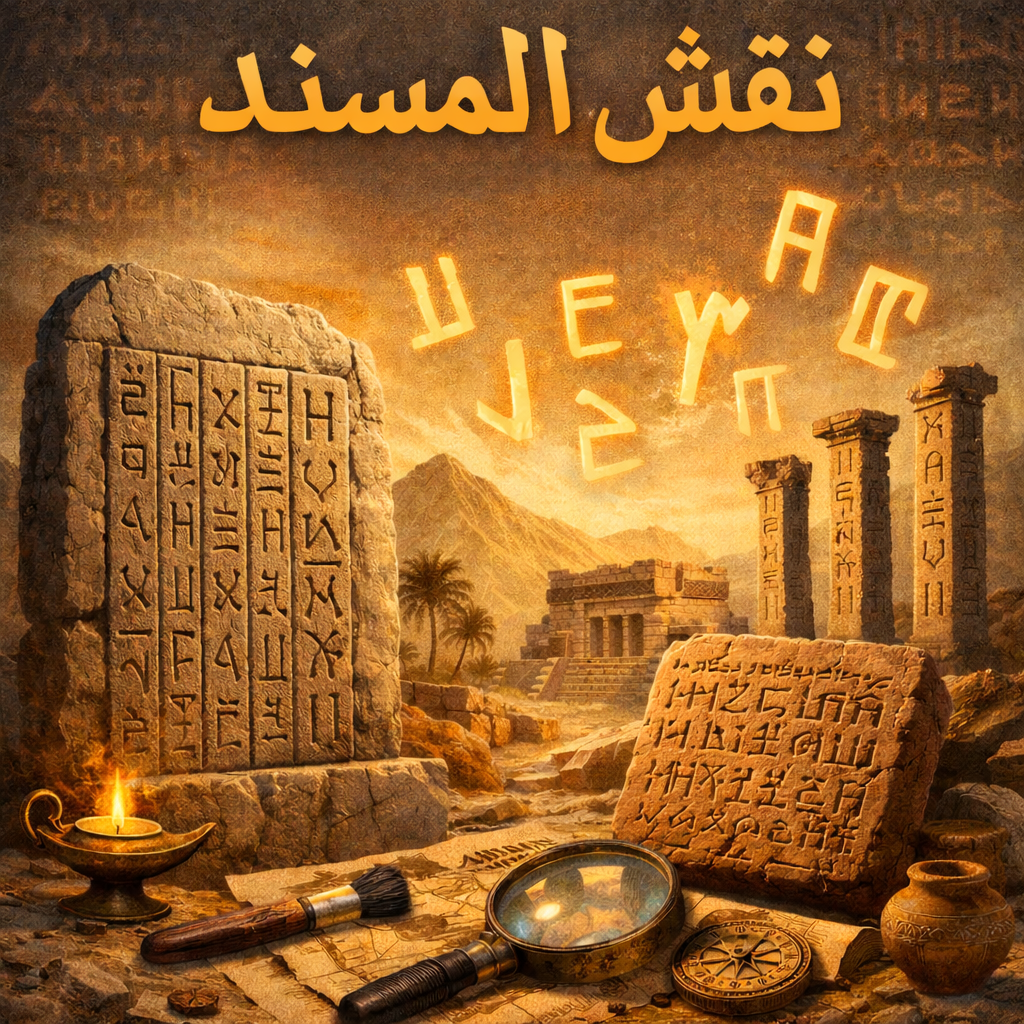


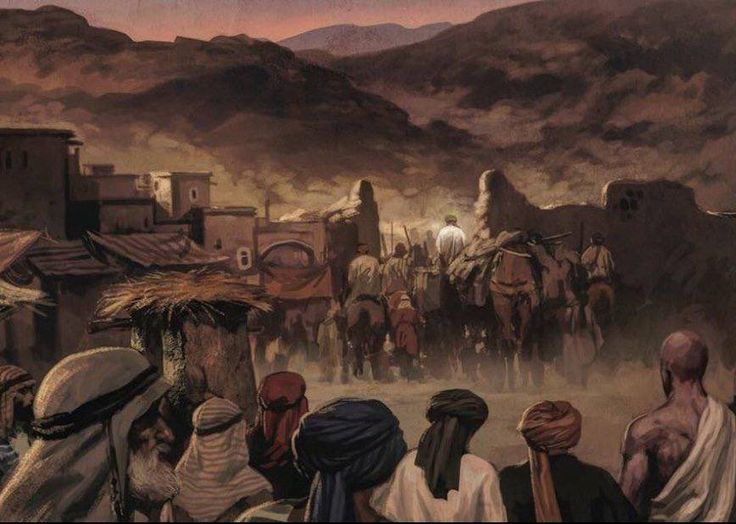
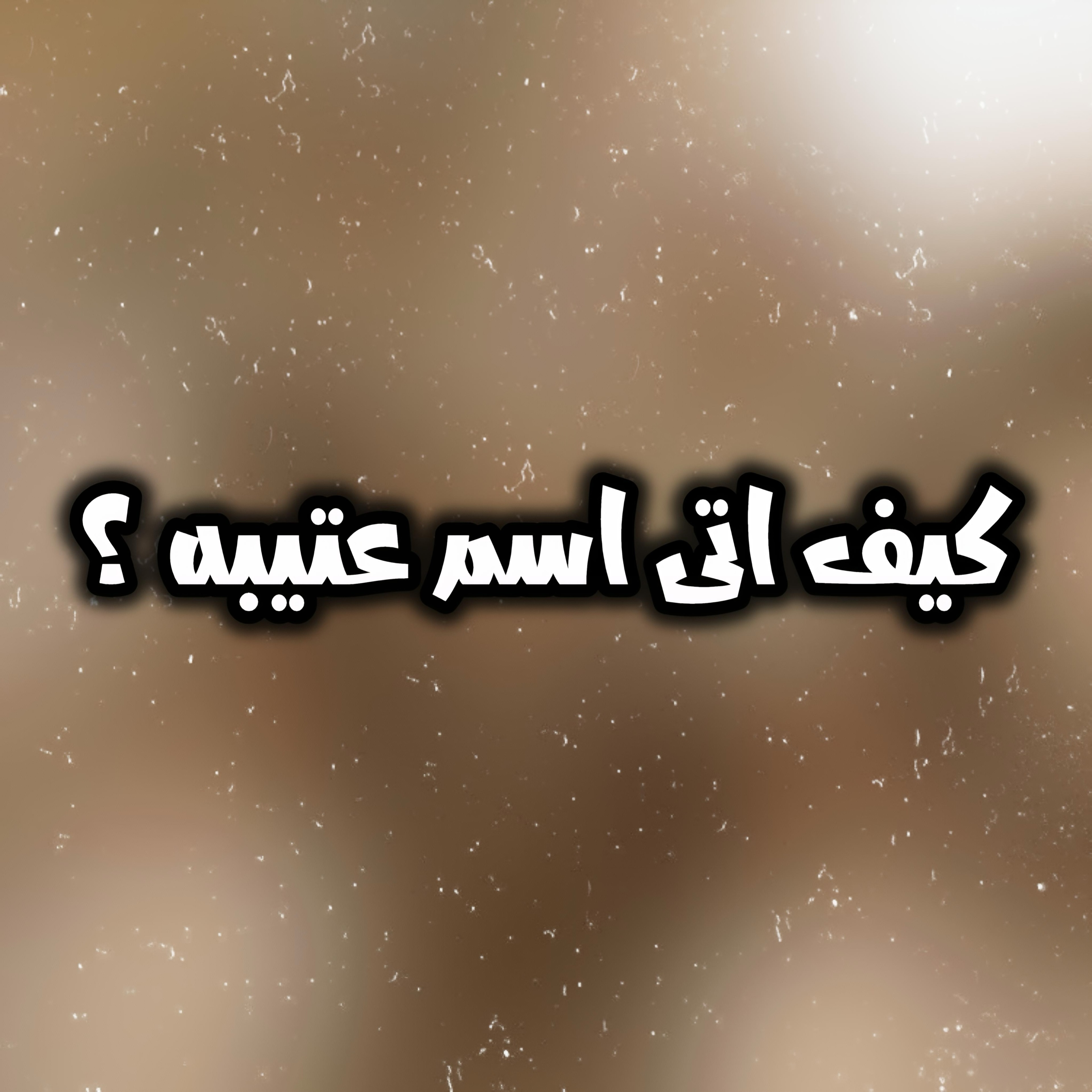
المداخلات العلمية (0)
انضم للمداخلات العلمية
سجل دخولك لتشارك وتضيف مداخلتك الأكاديمية على هذه الدراسة.
تسجيل الدخول للمشاركةلا توجد مداخلات بعد. كن أول من يضيف مداخلة!