مقدمة: لقبٌ حبَّرته السماء
إن تاريخ الإسلام، في جوهره، هو قصة تضحيات عظيمة وبطولات خالدة، ومن بين صفحات هذا التاريخ المشرق، تبرز جماعةٌ لم تكن مجرد قبيلة عربية أو فصيل تاريخي، بل كانت ركناً أساسياً وشرطاً ضرورياً لقيام دولة الإسلام الأولى. هؤلاء هم "الأنصار"، وهو ليس مجرد اسمٍ أطلقه عليهم الناس، بل هو وسام شرفٍ سماويّ، ولقبٌ منحه الله تعالى لهم، ليميزهم بمكانةٍ أبدية في وجدان الأمة. فعندما سُئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن هذا الاسم، أجاب بكلماتٍ ترسم حدود مكانتهم: "بل، سمَّانا الله به". هذه الحقيقة وحدها تنقل الحديث عن الأنصار من مجرد سردٍ تاريخي إلى استيعابٍ لمرتبة إيمانية فريدة، وتجعل من هويتهم وظيفة إلهية لا مجرد انتماء نسبي.
يهدف هذا التقرير إلى إعادة تسليط الضوء على الدور المحوري الذي لعبه الأنصار في تأسيس الإسلام وتمكينه. فبينما تحتفي الذاكرة الإسلامية، وبحق، بتضحيات المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم، فإن دور الأنصار، الذين ضحوا بسيادتهم وأمنهم واقتصادهم وحياتهم ليصنعوا وطناً جديداً للإسلام، قد لا يلقى أحياناً نفس القدر من التقدير في المخيال الشعبي. إن هذا البحث يسعى لاستعادة ذلك التوازن، ليس من باب المفاضلة التي لا تليق بمقام الصحابة، بل من باب التكامل الذي يُظهر الصورة الكاملة للمجتمع النبوي الفريد، حيث كان المهاجرون والأنصار جناحين طار بهما الإسلام نحو المجد.
بالاعتماد على نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، واستناداً إلى أمهات كتب السيرة والتاريخ، سيستعرض هذا التقرير رحلة الأنصار من غياهب الجاهلية إلى أنوار النبوة، محللاً الأدوار الحاسمة التي قاموا بها، والمناقب التي خُلِّدت في حقهم، مع الالتزام التام بعدم الانتقاص من قدر أي صحابي جليل، فمقاماتهم جميعاً محفوظة ومكانتهم عند الله عظيمة.
الجزء الأول: بوتقة يثرب: صياغة أمةٍ قُدِّر لها العظمة
لم يكن تاريخ الأنصار قبل الإسلام مجرد سلسلة من الأحداث العشوائية، بل كان إعداداً إلهياً وتمهيداً لدورهم التاريخي العظيم. فمن رحم المعاناة والفرقة، وُلدت الحاجة الماسة إلى الخلاص، ومن قلب يثرب، انبثق فجر النصرة.
الفصل الأول: من سيل العَرم إلى واحة يثرب
يمتد نسب الأنصار إلى أعرق القبائل العربية، فهم أبناء الأوس والخزرج، الذين يرجعون في أصلهم إلى قبيلة الأزد اليمانية القحطانية. وتذكر المصادر أن هجرتهم من اليمن ارتبطت بحدث تاريخي جلل، وهو تصدع سد مأرب، الذي كان عماد حضارتهم، مما دفع بطوناً من قبيلة الأزد إلى الهجرة شمالاً بحثاً عن مواطن جديدة. وكان الأوس والخزرج، ابنا حارثة بن ثعلبة الملقب بالعنقاء، من بين هؤلاء المهاجرين الذين استقر بهم المقام في واحة يثرب الخصبة.
عند وصولهم إلى يثرب، وجدوها تحت سيطرة قبائل يهودية قوية، مثل بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع، الذين كانوا يملكون الحصون والأراضي الزراعية. في البداية، عاش الأوس والخزرج في ظل هذه السيطرة، ولكن مع مرور الزمن، نمت قوتهم وتزايد عددهم، وبدأوا في منازعة اليهود على السيادة، حتى تمكنوا في نهاية المطاف من فرض وجودهم كقوة رئيسية في المدينة، خاصة بعد أحداث تاريخية مثل التخلص من الحاكم اليهودي المستبد "الفطيون". وهكذا، تحولت يثرب إلى موطنهم الذي هيأه القدر ليكون لاحقاً "مدينة الرسول".
الفصل الثاني: قرنٌ من الصراع وتمهيدٌ إلهي
رغم أنهم أبناء رجل واحد، وأمهم هي قيلة بنت كاهل التي كانوا يُنسبون إليها أحياناً فيقال "بنو قيلة"، فقد دبت العداوة بين قبيلتي الأوس والخزرج، ونشبت بينهما حروب طاحنة استمرت لأكثر من 120 عاماً. وقد شهدت هذه الفترة سلسلة من المعارك الدامية التي عُرفت في تاريخ العرب بـ "الأيام"، مثل يوم سمير ويوم البقيع.
كانت ذروة هذا الصراع الدموي في "يوم بعاث"، وهي معركة وقعت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات فقط. كانت هذه المعركة كارثية على الطرفين، حيث قُتل فيها معظم زعمائهم وساداتهم، وأنهكت قواهم، وتركتهم في حالة من الإنهاك واليأس لم يسبق لها مثيل. لم تكن هذه المعركة مجرد مأساة قبلية، بل كانت بمثابة تمهيد إلهي فريد. لقد حطمت هذه الحرب البنية القيادية التقليدية القائمة على العصبية الجاهلية، وأزاحت من المشهد الشخصيات التي كان من الممكن أن تقف عائقاً أمام أي سلطة جديدة موحِّدة. لقد خلقت فراغاً نفسياً وسياسياً، وجعلت قلوب أهل يثرب متعطشة للسلام والوحدة والأمان.
ومما زاد من تهيئتهم النفسية لقبول الرسالة الجديدة، أن جيرانهم من اليهود كانوا كثيراً ما يخبرونهم بقرب ظهور نبي، وأنهم سيتبعونه ويقاتلون العرب معه. هذه النبوءات خلقت حالة من الترقب الذهني، فعندما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته، لم تكن فكرة النبوة غريبة على أسماعهم. لقد كانت أرض يثرب، التي أرهقتها الحرب، هي التربة الخصبة التي استقبلت بذور الإسلام، بينما كانت أرض مكة، التي كانت في أوج قوتها وعصبيتها، هي الأرض الصلبة التي رفضت تلك البذور.
الجزء الثاني: الفجر يشرق من العقبة: بيعةٌ أسست أمة
في اللحظات التي بدا فيها أن دعوة الإسلام محاصرة في مكة، وأن أبواب القبائل قد أُغلقت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، انفتح باب النصر من حيث لم يحتسب أحد. لقد كانت يثرب هي الوجهة، وكان أهلها هم الوقود الذي أشعل نور الإسلام لينتشر في الآفاق.
الفصل الثالث: بيعتا العقبة - ميثاق الإيمان والفداء
بعد أن اشتد الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، خاصة بعد وفاة عمه أبي طالب وزوجه خديجة رضي الله عنها، أخذ يعرض نفسه على القبائل في مواسم الحج، داعياً إياهم إلى الله، وطالباً منهم النصرة والحماية، ولكن معظمهم رفض دعوته، بل إن عمه أبا لهب كان يتبعه ليكذبه ويصد الناس عنه. وفي خضم هذا اليأس الظاهري، وفي موسم الحج من السنة الحادية عشرة للبعثة، التقى النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة بستة رجال من قبيلة الخزرج، فعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. وبسبب ما كانوا يسمعونه من اليهود عن قرب مبعث نبي، وبسبب ما كانوا فيه من توقٍ إلى الوحدة والسلام، انشرحت صدورهم للإسلام فآمنوا وعادوا إلى قومهم رسل خير.
في العام التالي، عاد وفد أكبر مكون من اثني عشر رجلاً، عشرة من الخزرج واثنان من الأوس، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما عُرف بـبيعة العقبة الأولى أو "بيعة النساء". كانت هذه البيعة ميثاقاً أخلاقياً وتربوياً، تعاهدوا فيه على توحيد الله، واجتناب كبائر الذنوب كالسرقة والزنا وقتل الأولاد والبهتان، والطاعة في المعروف. كانت هذه البيعة هي اللبنة الروحية الأولى في صرح الدولة الجديدة.
لكن الحدث الذي غيّر مجرى التاريخ كان في العام الذي يليه، السنة الثالثة عشرة للبعثة، حين قدم وفد مكون من ثلاثة وسبعين رجلاً وامرأتين، وعقدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، التي عُرفت بـ "بيعة الحرب". لم تكن هذه مجرد بيعة على الإسلام، بل كانت تحالفاً سياسياً وعسكرياً شاملاً، وإعلاناً صريحاً عن استعدادهم لخوض حرب عالمية من أجل حماية هذه الدعوة. كانت بنودها ثورية بكل المقاييس:
- السمع والطاعة في المنشط والمكره، والعسر واليسر.
- النفقة في سبيل الله في الفقر والغنى.
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- أن يقولوا بالحق لا يخافون في الله لومة لائم.
- والبند الأخطر والأهم: أن ينصروه ويمنعوه إذا قدم إليهم مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأبناءهم، وأن يدافعوا عنه ضد "الأحمر والأسود" من الناس، أي البشرية جمعاء، والمقابل هو الجنة. لقد كانت هذه البيعة بمثابة إعلان ميلاد دولة الإسلام قبل أن تقوم على الأرض.
الفصل الرابع: المدينة المنورة - هجرةٌ أنجبت أمة
بعد بيعة العقبة الثانية، أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى يثرب، ثم هاجر هو بنفسه، فاستقبله الأنصار استقبالاً أسطورياً، لم يشهده التاريخ من قبل. لقد تحولت مدينتهم من "يثرب" إلى "مدينة الرسول"، وفتحوا قلوبهم وبيوتهم لإخوانهم المهاجرين. وكان حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم صادقاً وعميقاً، حتى إنه عندما رأى نساءهم وصبيانهم مقبلين من عرس، قام واقفاً وقال مكرراً: "اللهم! أنتم من أحب الناس إلي. اللهم! أنتم من أحب الناس إلي". هذه الكلمات لم تكن مجاملة عابرة، بل كانت شهادة نبوية على مكانتهم الخاصة في قلبه.
الفصل الخامس: المؤاخاة - معجزة اجتماعية واقتصادية
بمجرد وصوله إلى المدينة، قام النبي صلى الله عليه وسلم بعملٍ تشريعيٍّ عبقري، وهو "المؤاخاة" بين المهاجرين والأنصار. لم يكن هذا الإجراء مجرد لفتة رمزية، بل كان سياسة اجتماعية واقتصادية متكاملة، حلت بشكل فوري أزمة المهاجرين الذين وصلوا إلى المدينة لا يملكون شيئاً بعد أن تركوا كل أموالهم في مكة. لقد كان إيثار الأنصار هو المحرك الاقتصادي الذي قامت عليه الدولة. فبدون هذا البذل الذي لا مثيل له، كان المجتمع الإسلامي الوليد سينهار تحت وطأة الفقر والتفكك الاجتماعي.
وقد سجل التاريخ قصصاً مذهلة عن هذا الإيثار الذي بلغ حداً جعل المهاجرين أنفسهم يخشون أن يذهب الأنصار بكل الأجر.
- قصة سعد بن الربيع الأنصاري مع عبد الرحمن بن عوف المهاجري، حيث عرض عليه سعد أن يقاسمه نصف ماله كله، وأن يطلق له إحدى زوجتيه ليتزوجها عبد الرحمن. هذا العرض المذهل يجسد عمق البذل وكماله.
- عرض الأنصار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسموا نخيلهم بينهم وبين المهاجرين، فرفض النبي ذلك، واقترح حلاً وسطاً وهو أن يقوم المهاجرون بمشاركتهم في العمل ويقتسموا معهم الثمر، فقبلوا قائلين: "سمعنا وأطعنا".
- قصة الأنصاري الذي استضاف ضيفاً أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في بيته إلا طعام صبيانه، فأمر زوجته أن تنوّم الأطفال، وأطفأ السراج ليوهم ضيفه أنه يأكل معه، وبات هو وأهله جوعى. هذا الموقف العظيم كان سبباً في نزول آية قرآنية خالدة تشهد لهم بهذا الخلق الرفيع.
لقد كانت شهادة المهاجرين أنفسهم هي أصدق تعبير عن هذا الكرم المنقطع النظير، حيث قالوا: "يا رسول الله ما رأينا مثل قوم نزلنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أبذل في كثير منهم". لقد كان إيثارهم هو رأس المال التأسيسي الذي قامت عليه أول دولة في الإسلام.
الجزء الثالث: شهادة السماء: الأنصار في القرآن والسنة
إن أعظم ما يميز الأنصار ليس فقط ما قدموه من تضحيات، بل الكيفية التي خلد بها الوحي هذه التضحيات، وجعلها جزءاً من العقيدة الإسلامية، ومعياراً للإيمان. فمكانتهم ليست مجرد تقدير بشري، بل هي شهادة سماوية مسجلة في أقدس نصوص الإسلام.
الفصل السادس: آياتٌ كُتبت في الأزل - التوثيق الإلهي
خص الله سبحانه وتعالى الأنصار بآيات تتلى إلى يوم القيامة، تصف أفعالهم وتزكي نفوسهم وتضمن لهم الأجر العظيم. هذه الآيات هي بمثابة شهادات إلهية لا تقبل الشك.
- سورة الحشر، الآية 9: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾. هذه الآية هي اللوحة القرآنية التي ترسم ملامح الشخصية الأنصارية: استقرار في الإيمان، حبٌّ صادق للمهاجرين، سلامة صدر، وقمة العطاء المتمثل في الإيثار حتى مع الحاجة.
- سورة التوبة، الآية 100: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾. هنا، يضعهم الله في أعلى مراتب المؤمنين، جنباً إلى جنب مع السابقين من المهاجرين، ويعلن رضاه الأبدي عنهم، وهو أسمى ما يطمح إليه مؤمن.
- سورة الأنفال، الآيتان 72 و 74: ﴿وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ و ﴿وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾. تحدد هاتان الآيتان وظيفتهم (الإيواء والنصرة)، ثم تمنحهم شهادة "المؤمنون حقاً"، مع وعد إلهي بالمغفرة والرزق الكريم.
- سورة التوبة، الآية 117: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ﴾. توثق هذه الآية ثباتهم وصبرهم في أصعب الظروف، وتؤكد شمولهم بالرحمة والمغفرة الإلهية.
الفصل السابع: "آية الإيمان" - الشهادة النبوية
لم تقتصر الشهادة على القرآن، بل جاءت السنة النبوية لتفصل هذه المكانة وتؤكدها بأحاديث صحيحة متواترة، ترسم علاقة فريدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأنصاره.
- المعيار العقدي: الحديث الذي رواه البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله". هذا الحديث يجعل من حب الأنصار "آية" وعلامة فارقة بين الإيمان والنفاق، ويربط حبهم بحب الله، وبغضهم ببغض الله. إنه ليس مجرد مدح، بل هو تأسيس لقاعدة عقدية.
- التماهي الروحي: قوله صلى الله عليه وسلم: "لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم". يعبر هذا الحديث عن تماهٍ روحي كامل، وانتماء قلبي عميق، حتى إنه لو لم يكن هناك اعتبار للهجرة التي شرفه الله بها، لكان قد عد نفسه واحداً منهم.
- أهل الخاصة والمقربون: وصفه لهم بقوله: "الأنصار شعار والناس دثار". الشعار هو الثوب الملاصق للجسد، والدثار هو ما فوقه. هذا التشبيه البليغ يوضح أن الأنصار هم أقرب الناس إليه، وألصقهم به، فهم أهل سره وخاصته.
- الوصية الخالدة للأمة: قوله صلى الله عليه وسلم في أواخر أيامه: "أيها الناس تكثرون ويقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي من أمرهم شيئا فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم". هذه وصية سياسية وتشريعية موجهة لكل حكام المسلمين من بعده، تفرض عليهم رعاية الأنصار رعاية خاصة.
- دعاءٌ يمتد للأجيال: دعاؤه الخاص الذي لم يخص به غيرهم: "اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار". هذا الدعاء يغمر أجيالهم بالرحمة الإلهية، وهو تكريم فريد لنسلهم.
جدول 1: خلاصة الأحاديث النبوية في فضائل الأنصار
لتركيز هذه الشهادات النبوية، يمكن تلخيص أبرزها في الجدول التالي، الذي يمثل مرجعاً سريعاً وموثقاً لمكانتهم في السنة.
| نص الحديث الشريف (بالعربية) | الترجمة | المصدر (مثال: البخاري، مسلم) | الفضيلة الأساسية |
|---|
| آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار | علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار. | صحيح البخاري | معيار عقدي للإيمان |
| لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار | لولا الهجرة لكنت رجلاً من الأنصار. | صحيح البخاري | التماهي الروحي الكامل للنبي معهم |
| الأنصار شعار والناس دثار | الأنصار هم الثوب الداخلي والناس هم الثوب الخارجي. | صحيح البخاري | قرب ومكانة لا تضاهى |
| أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي | أوصيكم بالأنصار خيراً، فإنهم خاصتي وموضع سري. | صحيح البخاري | وصية نبوية خالدة للأمة |
| اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار... | اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار... | صحيح مسلم | رحمة إلهية ممتدة للأجيال |
الجزء الرابع: السيف والدولة: مهندسو النصر والحكم
لم يقتصر دور الأنصار على الإيواء والدعم المادي، بل كانوا القوة العسكرية الضاربة والركيزة السياسية التي أمنت استقرار الدولة الإسلامية الناشئة وحمتها من أعدائها في الداخل والخارج.
الفصل الثامن: أسود الميدان - القوة العسكرية التي لا غنى عنها
شكل الأنصار العمود الفقري للجيش الإسلامي في غزواته الأولى. ففي معركة بدر الكبرى، التي كانت المعركة الفاصلة في تاريخ الإسلام، كان عددهم يفوق 70% من إجمالي الجيش. وقبل المعركة، برز موقفهم الحاسم الذي غير مسار الأحداث. فبيعة العقبة كانت تلزمهم بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم داخل المدينة، أما الخروج للقتال في بدر فكان خارج نطاق هذا العهد. وعندما استشارهم النبي صلى الله عليه وسلم، قام سيدهم سعد بن معاذ رضي الله عنه ليعلن عن توسيع طوعي لهذا الميثاق العسكري بكلمات خالدة: "فامضِ يا رسول الله لما أردت، فنحن معك... فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر، فخضته لخضناه معك، ما تخلف منَّا رجل واحد". لقد كان هذا إعلاناً بالولاء المطلق، وتفويضاً كاملاً لقيادته العسكرية.
ولم تكن مساهمتهم مجرد عدد، بل كانت أيضاً فكراً استراتيجياً. ففي بدر، كان الأنصاري الحباب بن المنذر هو الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير موقع الجيش للسيطرة على آبار المياه، وهو ما تبناه النبي قائلاً: "لقد أشرت بالرأي". وبرز منهم قادة عسكريون فذّون مثل سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، وأسيد بن حضير، الذين قادوا جيوش المسلمين في أحلك الظروف.
الفصل التاسع: السقيفة - أزمة الخلافة وشهادة الإيمان
تعتبر حادثة "سقيفة بني ساعدة" من أكثر اللحظات حساسية في التاريخ الإسلامي، ولكن فهمها في سياق شخصية الأنصار يغير منظورها بالكامل. فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن اجتماع الأنصار في السقيفة سعياً مبكراً للسلطة، بقدر ما كان تحملاً للمسؤولية. فهم أهل المدينة، وحماة الدولة، وكان استقرارها بعد غياب قائدها هو همهم الأول.
كان منطقهم واضحاً وقوياً، كما عبر عنه خطيبهم: "نحن أنصار الله وكتيبة الإسلام". واقتراحهم "منا أمير ومنكم أمير" كان حلاً سياسياً مبنياً على دورهم التأسيسي وتضحياتهم الجسيمة. ولكن عندما وصل كبار المهاجرين، ودار الحوار، وذكّر أبو بكر الصديق رضي الله عنه بحديث النبي "قريش ولاة هذا الأمر"، تجلت عظمة الأنصار مرة أخرى. لم يجادلوا أو يتمسكوا برأيهم، بل كان جواب سيدهم سعد بن عبادة فورياً ونبيلاً: "صدقت، نحن الوزراء وأنتم الأمراء".
إن هذا التنازل لم يكن هزيمة سياسية، بل كان قمة الإيثار. فبعد أن آثروا إخوانهم بأموالهم وديارهم، وآثروا نبيهم بأرواحهم، ها هم الآن يؤثرون وحدة الأمة على حقهم المشروع في القيادة. لقد كان خوفهم من عودة الفرقة بين الأوس والخزرج، التي ذاقوا مرارتها في يوم بعاث، هو الدافع الأكبر وراء مسارعة قادتهم، مثل بشير بن سعد وأسيد بن حضير، لمبايعة أبي بكر، حفاظاً على كيان الأمة. لقد كانت السقيفة هي آخر وأعظم تضحيات الإيثار الأنصارية.
الفصل العاشر: ما وراء الجزيرة - استمرار الرسالة في الفتوحات الكبرى
لم يتوقف دور الأنصار العسكري بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل استمروا في كونهم جزءاً لا يتجزأ من جيوش الفتح في عهد الخلفاء الراشدين. وتؤكد المصادر مشاركتهم الفعالة في الفتوحات الإسلامية الكبرى، سواء في جبهات الشام ومصر، أو في جبهات العراق وبلاد فارس. لقد كانوا حاضرين في كل الميادين، يواصلون المهمة التي بايعوا عليها في العقبة: نصرة دين الله حتى يبلغ مشارق الأرض ومغاربها.
الجزء الخامس: إرث النور: حراس العلم الإلهي
لم تكن عظمة الأنصار في سيفهم وكرمهم فحسب، بل كانت أيضاً في عقولهم وقلوبهم التي كانت أوعية لحفظ ونقل كنوز الإسلام: القرآن والسنة. لقد كانوا أعمدة العلم والمعرفة في الجيل الأول.
الفصل الحادي عشر: كتبة الوحي وأساتذة الشريعة
برز من الأنصار عمالقة في العلوم الشرعية، كلفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم المهام، وشهد لهم بالعلم والفضل.
- زيد بن ثابت: كان كاتب الوحي الأول للنبي صلى الله عليه وسلم. وبسبب ثقته وأمانته وعلمه، كلفه الخليفتان أبو بكر ثم عثمان بالمهمة التاريخية الأعظم، وهي جمع القرآن الكريم في مصحف واحد. وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه "أفرضهم"، أي أعلم الصحابة بعلم المواريث، وهو من أدق علوم الشريعة.
- أُبيّ بن كعب: كان من كبار كتبة الوحي أيضاً، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه "أقرأ الأمة لكتاب الله"، فكان مرجعاً في علم القراءات والتفسير.
- معاذ بن جبل: أرسله النبي صلى الله عليه وسلم قاضياً ومعلماً إلى اليمن، وهي شهادة عملية على مكانته العلمية، وقد قال عنه: "أعلم أمتي بالحلال والحرام".
هؤلاء، ومعهم آخرون كأبي الدرداء وأبي أيوب الأنصاري، شكلوا المدرسة العلمية الأولى في المدينة، التي تخرج منها كبار التابعين.
الفصل الثاني عشر: رواة حكمة النبوة
إذا كان القرآن هو دستور الأمة، فإن السنة هي بيانها وتطبيقها العملي. وقد كان للأنصار دور محوري في حفظ ونقل هذا الإرث النبوي. فمن بين الصحابة السبعة الأكثر رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يُعرفون بـ"المكثرين"، كان ثلاثة منهم من الأنصار.
- أنس بن مالك: خادم النبي صلى الله عليه وسلم الذي لازمه عشر سنين، فكان أعلم الناس بتفاصيل حياته اليومية. روى 2,286 حديثاً.
- جابر بن عبد الله: كان من المكثرين في الرواية والفتوى، وقد روى 1,540 حديثاً.
- أبو سعيد الخدري: من فقهاء الصحابة الشباب، وكان مرجعاً في الحديث والفقه، وروى 1,170 حديثاً.
إن وجود ثلاثة من كبار رواة الحديث من الأنصار يعني أن جزءاً كبيراً من السنة النبوية التي بين أيدينا اليوم قد وصل إلينا عبرهم، مما يجعلهم بحق "حراس حكمة النبوة".
جدول 2: كبار العلماء ورواة الحديث من الأنصار
يلخص هذا الجدول المساهمة الفكرية الهائلة للأنصار، ويظهر أنهم لم يكونوا مجرد "مساعدين"، بل كانوا "أساتذة" الأمة الأوائل.
| الشخصية | القبيلة (أوس/خزرج) | مجال التخصص | المساهمة الرئيسية / شهادة نبوية | عدد الأحاديث المروية |
|---|
| زيد بن ثابت | الخزرج | جمع القرآن، علم المواريث | كاتب الوحي الرئيسي، "أعلمهم بالفرائض". | ~92 |
| أُبيّ بن كعب | الخزرج | القراءات، التفسير، الفقه | "أقرأ الأمة لكتاب الله". | 164 |
| معاذ بن جبل | الخزرج | الفقه، الحلال والحرام | "أعلم الأمة بالحلال والحرام". | 157 |
| أنس بن مالك | الخزرج | رواية الحديث | خدم النبي ﷺ 10 سنوات، معرفة دقيقة بحياته. | 2,286 |
| جابر بن عبد الله | الخزرج | رواية الحديث، الفقه | مرجع رئيسي في سيرة النبي ﷺ وتعاليمه. | 1,540 |
| أبو سعيد الخدري | الخزرج | رواية الحديث، الفقه | من كبار فقهاء الصحابة الشباب. | 1,170 |
خاتمة: النبوءة، والوعد، ومسؤوليتنا
في ختام هذه الرحلة مع تاريخ الأنصار ومناقبهم، نصل إلى حديث نبوي مؤثر يحمل في طياته نبوءة ووعداً وتوجيهاً. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنصاره بما سيواجهونه من بعده، فقال: "إنكم سترون بعدي أثرة"، أي استئثاراً وتفضيلاً لغيرهم عليهم في أمور الدنيا. كانت هذه نبوءة بما سيقع، ولكنها لم تكن دعوة للثورة أو الشكوى، بل جاء معها الأمر الإلهي بالصبر: "فاصبروا حتى تلقوني على الحوض".
إن هذه النبوءة لم تكن تنبؤاً بفشلهم الدنيوي، بل كانت أعظم شهادة بنجاحهم الأخروي. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد توجيه طموحهم من السلطة الزائلة إلى المكافأة الباقية، ومن المناصب الفانية إلى لقاء خالد معه شخصياً عند حوضه الشريف. لقد كان صبرهم على الظلم هو آخر وأعظم امتحان لإيمانهم، وجائزتهم هي هذا الوعد النبوي الذي لا يُخلف.
إن مجد الأنصار، كما رأينا، ليس مجداً تاريخياً يمكن أن يبهت، أو مكانة سياسية يمكن أن تُنتزع، بل هو مجدٌ سماويٌّ محفور في آيات القرآن وأحاديث سيد الأنام. حبهم علامة الإيمان، وأفعالهم خلدها الوحي، ووصية النبي بتكريمهم هي أمانة في عنق كل مسلم إلى يوم الدين.
وتبقى علينا اليوم مسؤولية عظيمة: أن نعيد اكتشاف هذا الإرث العظيم، وأن نحتفي به، وأن نتعلم من دروسه في الإيثار والأخوة والتضحية والإيمان الراسخ. إن حب الأنصار هو من حب رسول الله، ودراسة سيرتهم هي فهم لجوهر الإسلام. وتطبيق وصية النبي فيهم "فاقبلوا من محسنهم، وتجاوزوا عن مسيئهم" هو واجب جماعي، وطريق لتقوية قلب هذه الأمة واستعادة روحها الأصيلة.
 إسماعيل الأنصاري
إسماعيل الأنصاري 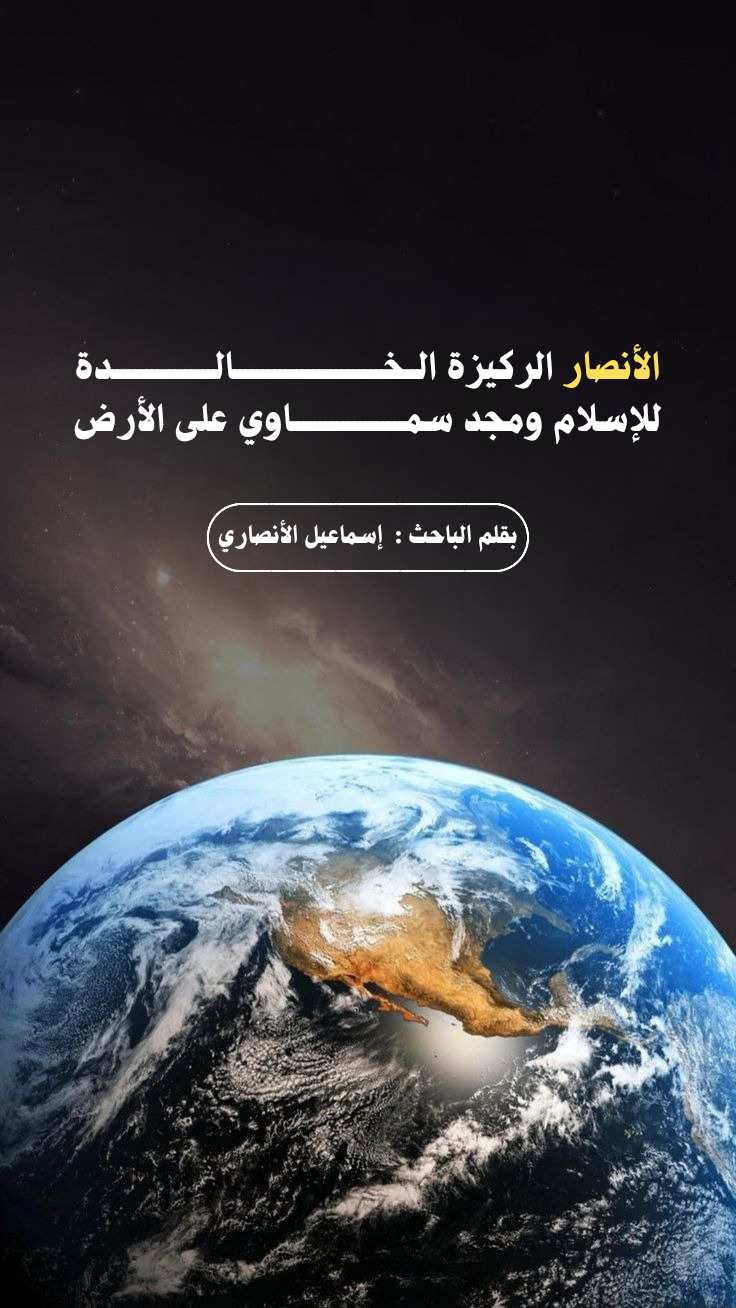

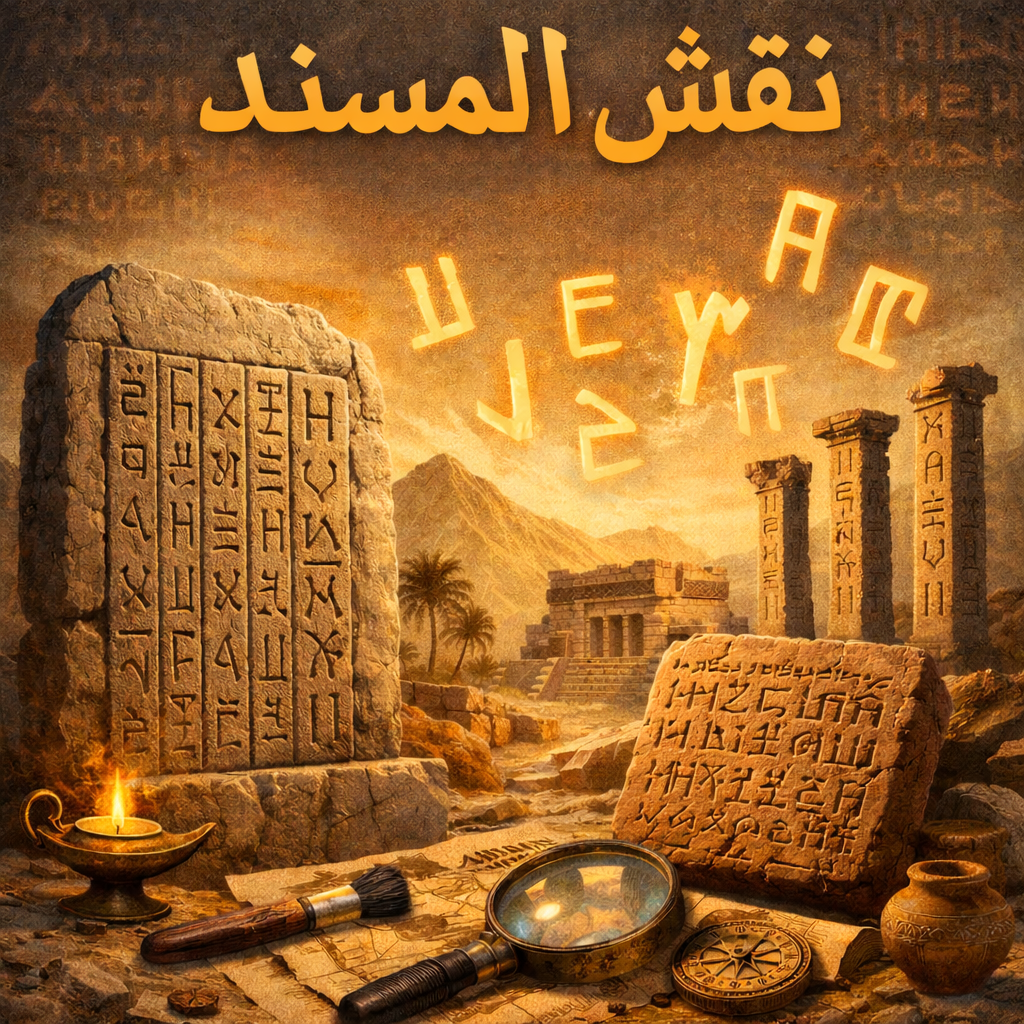


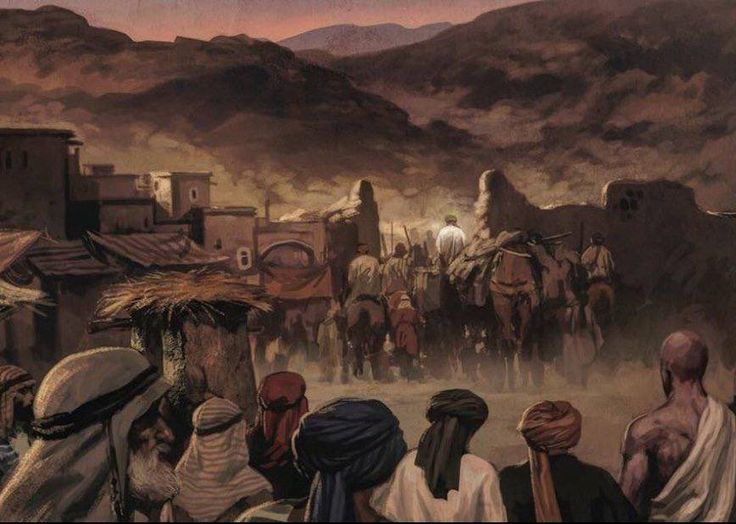
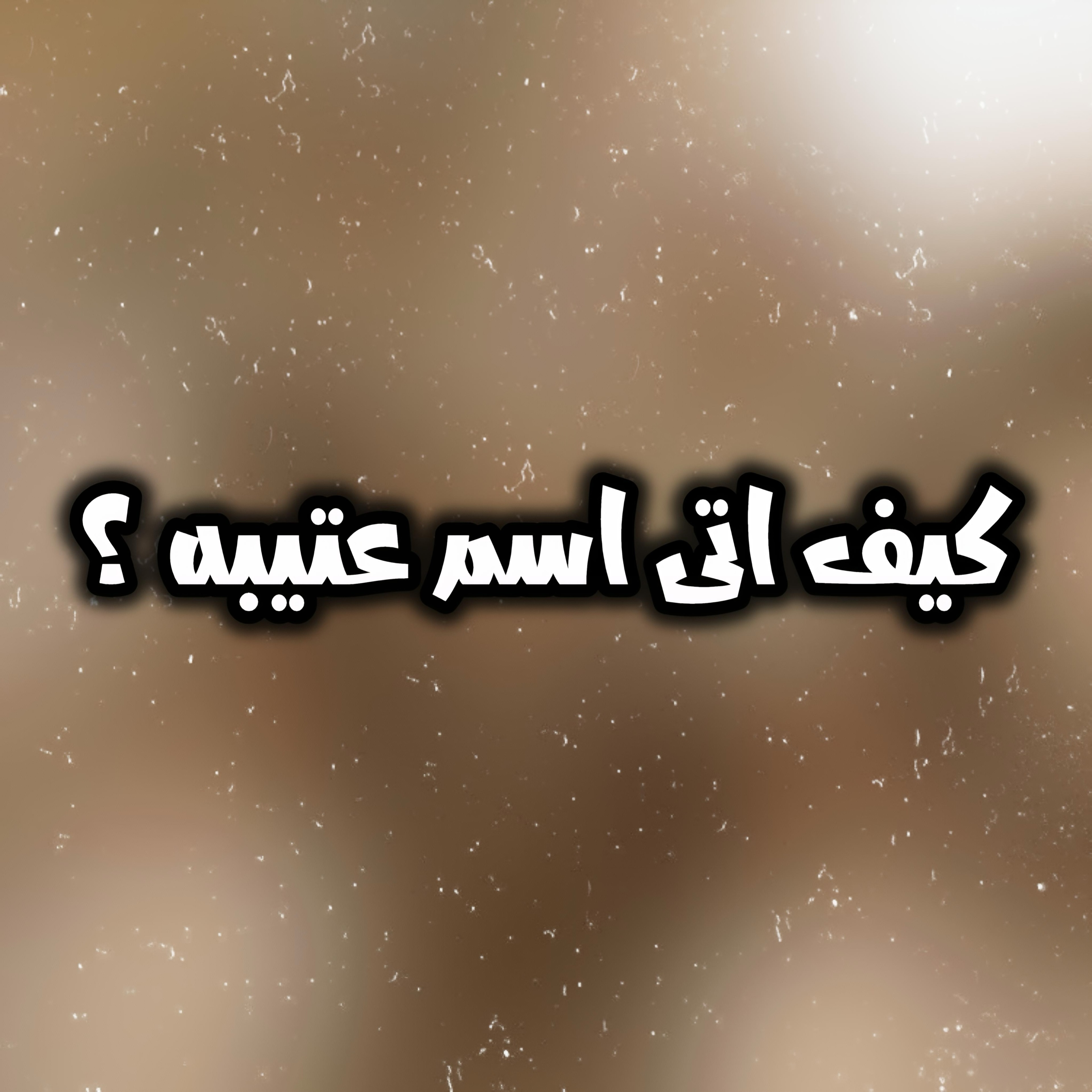
المداخلات العلمية (1)
انضم للمداخلات العلمية
سجل دخولك لتشارك وتضيف مداخلتك الأكاديمية على هذه الدراسة.
تسجيل الدخول للمشاركةياسر الانصاري
منذ 4 شهور